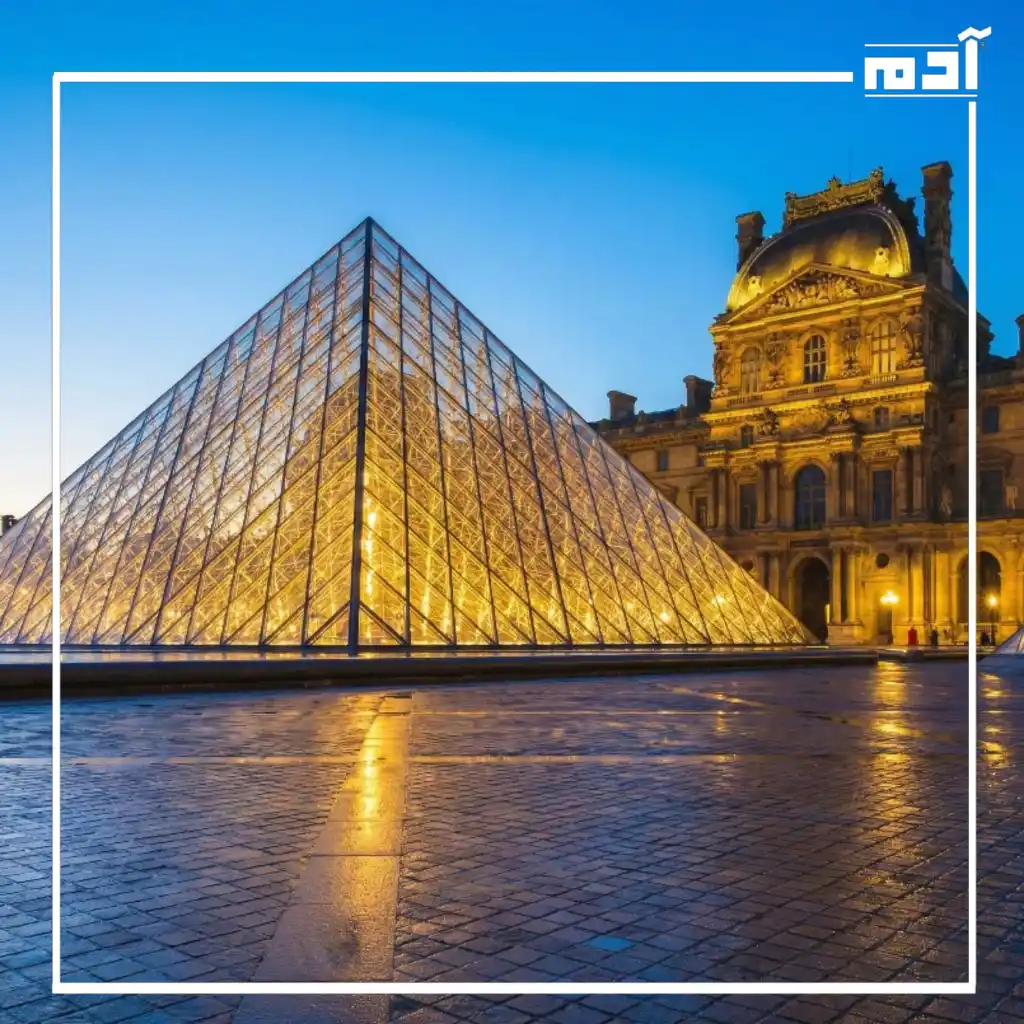في عصر سابق حيث كانت العبودية لا تزال موجودة على رغم إنتشار الإسلام وباقي الديانات السماوية التي حرمت العبودية، إتسم هذا العصر بإحدى أسوء العهود السياسية حيث إنتشرت وإندثرت عشرات الدول التي قامت تحت مظلة الخلافة العباسية، فكانت هذه الدول تأكل بعضها بعضاً، ويدفع المواطنون الثمن دائماً، حيث يكون مصيرهم الدائم القتل والتخريب والتشريد، وأيضاً الاختطاف والرق، أما هؤلاء الذين يختطفون من أهاليهم فكانوا يباعون في أسواق النخاسة فيقوم أشخاص آخرين بشرائهم ليكونوا خدماً أو مماليك وجواري.
كما وجدً دول تنفق بغزارة في شراء المماليك والجواري، فبنوا جيوش كاملة من المماليك وتمتعوا بصحبة الجواري كملك يمين لهم وعلى رأس هذه القائمة الدولة الأيوبية، التي ورثت مُلك السلطان الناصر أبو المظفر صلاح الدين يوسف الأيوبي، فقد عانت الدولة الأيوبية من هجمات متكررة بسبب الصراع الداخلي على كرسي السلطنة في القاهرة، ولم يرى أمراء بني أيوب الخطر القادم من الشرق الذي سوف يهز العالم الإسلامي هزاً، بل والأسوأ أنهم تعايشوا مع الخطر الصليبي الغربي الذي لا يزال يهدد العالم الإسلامي آنذاك، فتناحروا فيما بينهم طمعاً في السلطة، ووصل المماليك فأصبحوا أمراء.
-أُصول المماليك:
لم يكن الأيوبيون أول من إستخدم المماليك في جيش الولاية المصرية، فعندما عيَّن الخليفة العبَّاسي أبو العبَّاس أحمد المُعتمد على الله أحمد بن طولون التُركيّ الأصل، واليًا على الديار المصريَّة عام 263هـ المُوافق لِسنة 877م، طمع في الإستقلال بها بعد أن أضحت جميع أعمالها الإداريَّة والقضائيَّة والعسكريَّة والماليَّة بِيده،وحتَّى يُحقق أحمد بن طولون رغبته في الإستقلال بحُكم مصر رأى أن يدعم سُلطته بِجيشٍ مملوكيٍّ من التُرك من بني جنسه بِالإضافة إلى العُنصر الديلمي، وبلغ تعداد هذا الجيش ما يزيد عن أربعةٍ وعشرين ألف غُلامٍ تُركيٍّ ومُنذُ ذلك الوقت صار جُندُ مصر ووُلاتها من المماليك التُرك، ولمَّا توسَّعت حُدود الدولة الطولونيَّة لِتشمل الشَّام،بات حالُ جُند الشَّام كحال جُند مصر،كما نهجت الدولة الإخشيديَّة أيضآ “التي خلفت الدولة الطولونيَّة في حُكم مصر”نهج هذه الدولة الأخيرة في الإعتماد على المماليك وبلغ تعداد مماليك مُحمَّد بن طُغج الإخشيدي مُؤسس الدولة الإخشيديَّة نحو ثمانية آلاف مملوكٍ من التُرك والديلم، وقيل أنَّهُ كان ينام بِحراسة ألف مملوك.
ولمَّا إستولى الفاطميُّون على مصر سنة 358هـ المُوافقة لِسنة 969م إعتمد خُلفائهم الأوائل مُنذُ أيَّام أبي تميم معدّ المُعز لِدين الله على عدَّة عناصر تُركيَّة وزنجيَّة وبربريَّة وصقلبيَّة وإستخدم الخليفة الفاطمي أبو منصور نزار العزيز بِالله التُرك في الوظائف العامَّة والقياديَّة في الدولة، وفضَّلهم على غيرهم من العرقيَّات الأُخرى، فولَّى مملوكه «منجوتكين» التُركي قيادة الجيش، كما ولَّاه الشَّام. وكان نُفُوذُ المماليك التُرك يتزايد أو يتناقص وفق توجُّه كُل خليفةٍ فاطميٍّ على حدى، ففي عهد أبو عليّ المنصور الحاكم بِأمر الله تراجع نُفوذهم لِحساب الزُنج، ثُمَّ نشطو مرَّة أُخرى في عهد الخليفة أبو الحسن عليّ الظاهر لِإعزاز دين الله الذي جعل قيادة الجُيُوش في يد المملوك التُركيّ الأصل منصور أنوشتكين،وولَّاه الظاهر دمشق في 419هـ المُوافقة 1028م.
إهتمَّ الفاطميُّون بِتربية صغار مماليكهم وفق نظامٍ خاص، وهم أوَّل من وضع نظامًا منهجيًّا في تربية المماليك في مصر.
وفي سنة 567هـ المُوافقة لِسنة 1171م، سقطت الدولة الفاطميَّة في مصر وقامت الدولة الأيُّوبيَّة على أنقاضها، لِتفتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأدنى والمماليك معًا وكان الأيُّوبيين – الأكراد أصلًا – قد تربُّوا ونمت سُلالتهم في أحضان الدولة السُلجُوقيَّة التُركيَّة ومماليكها، فنقلوا عنها الكثير من عاداتها وأنظمتها التُركيَّة المشرقيَّة،وكان الأيُّوبيين يُربُّون مماليكهم على أساس النظام الإسلامي المملوكي – الساماني الذي وضعهُ الوزير السُلجُوقي نظام المُلك وفصَّلهُ في كتابه «سياسة نامه»، ثُمَّ يتم إدخالهم في خدمة القُصُور السُلطانيَّة والدوائر الحُكُوميَّة.
ولمَّا توجَّه القائد أسدُ الدين شيركوه إلى مصر لِنُصرة آخر الخُلفاء الفاطميين أبو مُحمَّد عبدُ الله العاضد لِدين الله ولِلحيلولة دون إحتلال البلاد من قِبل الصليبيين، كان غالبيَّة جيشه يتألَّف من المماليك التُرك القفجاق الذين سُمُّوا بـ«المماليك الأسديَّة» نسبةً له، أي أسدُ الدين، ثم بعد وفاته وقف المماليك الأسديَّة إلى جانب ابن أخيه صلاحُ الدين وناصروه حتَّى تولَّى الوزارة في مصر، وأنشأ هذا الأخير لِنفسه جيشًا خاصًا عماده المماليك الأسديَّة والأحرار الأكراد، بِالإضافة إلى المماليك التُرك الذين إشتراهم لِنفسه وسمَّاهم «الصلاحيَّة» أو «الناصريَّة»، كما كان لِأخيه العادل أبي بكر أحمد طائفةٌ من المماليك سمَّاهم «العادليَّة».
إشتركت فئات المماليك الأسديَّة والصلاحيَّة والعادليَّة في مُختلف المعارك التي خاضها صلاحُ الدين ضدَّ الأُمراء المُسلمين بِهدف تحقيق الوحدة الإسلاميَّة وضدَّ الصليبيين بِهدف طردهم من ديار الإسلام والواقع أنَّ المماليك بلغوا في هذه المرحلة مبلغًا من القُوَّة ممَّا دفع صلاح الدين إلى إستشارتهم والنُزُول لإرادتهم في كثيرٍ من الأحيان.
إزداد عددهم في مصر والشَّام بعد وفاة صلاح الدين في سنة 589هـ،1193م بِشكلٍ مُلفت، وبرزوا على أثر إشتداد التنافس والصراع بين ورثته من أبنائه وإخوته وأبناء إخوته الذين إقتسموا الإرث الأيُّوبي بينهم، ومع تنامي قُوَّة المماليك نتيجة كثرة إعتماد الأُمراء الأيُّوبيين عليهم، أخذوا يتدخَّلون في خلع هؤلاء الأُمراء والسلاطين وتنصيبهم.
-نهاية بني أيوب في مصر:
بعد وفاة الملك الكامل ناصرُ الدين مُحمَّد الأيُّوبي سنة 635هـ ، 1238م عارض مماليكه ما جرى من تنصيب ابنه الأصغر العادل سيفُ الدين أبو بكر، فتحالفوا مع المماليك الأشرفيَّة بِزعامة عز الدين أيبك الجاشنكير التركماني الصالحي النجمي، وتآمروا على خلع أبي بكر سنة 637هـ ، 1240م، وهزموا من ناصرهُ من الكُرد،ثم فرض المماليك الكامليَّة (مماليك الملك الكامل ناصر الدين) -وكانوا الأقوى على الساحة السياسيَّة- رغبتهم على الأشرفيَّة بِتنصيب نجم الدين أيُّوب بن مُحمَّد، فإستُدعي الأخير من حصن كيفا في الجزيرة الفُراتيَّة لِتولِّي السُلطة في مصر التي دخلها سنة 638هـ ، 1240م، وجلس على العرش وتلقَّب بِالملك الصَّالح.
كانت قضيَّة تنصيب الملك الصَّالح سابقةً في تاريخ مصر والإسلام، إذ قام المماليك لِأوَّل مرَّة بِدورٍ سياسيٍّ ضاغطٍ، فأضحوا الأداة لِلسلاطين الأيُّوبيين لِلاحتفاظ بِسُلطانهم وتفُّوقهم، ممَّا أدَّى إلى تضخُّم نُفُوذهم السياسي، وإزدادوا شُعُوراً بِأهميَّتهم.
أدرك الصَّالح أيُّوب أهميَّة المماليك لِلإستمرار في الحُكم ما دفعهُ إلى الإكثار من شرائهم إلى درجةٍ لم يبلغْها غيره من الأمراء الأيوبيين حتَّى أضحى مُعظم جيشه منهم، وإعتنى بِتربيتهم تربيةً خاصّةً ثُمَّ جعلهم بطانته وحرسه الخاص، إستغلَّ المماليك الصالحيَّة سطوتهم في مُضايقة الناس والعبث بِمُمتلكاتهم وأرزاقهم، حتَّى ضجَّ الشعب من عبثهم وإعتداءاتهم، فرأى الصَّالح أيُّوب أن يُبعدهم عن العاصمة، وإختار جزيرة الروضة في النيل لِتكون مقراً له، فانتقل إليها مع حاشيته ومماليكه الذين بنى لهم قلعة خاصَّة أسكنهم بها، فعُرفُوا مُنذُ ذلك الحين بِـ«المماليك البحريَّة الصالحيَّة».
• معركة المنصورة:
تعرَّضت مصر أواخرَ أيَّامِ الصَّالح أيُّوب لغزوٍ صليبيٍّ كبير بِقيادة لويس التاسع ملك فرنسا [ما اصطلح عليه بالحملة الصليبيةِ السابعة]، ففي فجر السبت 22 صفر 647هـ ، 5يونيو 1249م نزل الصليبيُّون برَّ مدينة دُمياط، واحتلُّوا المدينة بِسُهولة بعد إنسحاب حاميتها وهروب أهلها منها،وتُوفي في تلك الفترة الحرجة الصَّالح أيُّوب بعدما إشتدَّ عليه المرض، فأخفت زوجته شجرة الدُّر موته خشية تضعضع الأوضاع، وأرسلت تدعو ابنه الوحيد توران شاه من حصن كيفا لِلقُدوم لمصر على عجلٍ لِيتولَّى الحُكم،علم الصليبيُّون بِوفاة الصَّالح أيُّوب رُغم كُل الإحتياطات التي إتخذتها شجرة الدُّر لِإخفاء الأمر، فاتخذوها فُرصةً لِتوجيه ضربةٍ قاضيةٍ لِلمُسلمين قبلما يفيقوا من هول الصدمة، فزحفوا من دُمياط نحو المنصورة، عندها أمسك المماليك بِزمام الأُمُور بِقيادة فارس الدين أقطاي الجمدار، الذي أصبح القائد العام لِلجيش (أتابك العسكر)، ووضع أحد أبرز قادتهم ركن الدين بيبرس البندقداري خطَّة عسكريَّةً مُحكمةً كفلت النصر على الصليبيين، وفي تلك الأثناء وصل توران شاه إلى مصر وتسلَّم مقاليد الأُمُور، وأعدَّ خطَّةً أُخرى ضمنت النصر النهائي على الصليبيين في قرية فارَسْكور، فهُزم هؤلاء هزيمةً كُبرى وفَنيَ جيشهم على يد المماليك، ووقع لُويس التاسع نفسهُ في الأسر، وقتل أخاه الأمير دارتوا في المعركة.
بهذا الشكل إنتهت الحملة الصليبيَّة على مصر بِفضل جُهُود المماليك، ولكن ظهرت مشكلة أخرى، حيث إشتهر السُلطان الجديد توران شاه بِأنَّهُ شخصيَّة عابثة، وعرف بِسُوء الخلق والتصرُّف والجهل بِشُؤون الحُكم والسياسة، فبعد إنتصاره على الصليبيين إزداد غُروره وتناسى ما أبلاه مماليك أبيه من صد الصليبيين، فلم يُقدِّر ثمن هذا النصر، كما لم يُقدِّر جُهودهم في الحفاظ على نظام الحُكم كي يُؤمِّنوا العرش له، ويبدو أنَّه فقد ثقته بهم بعد إنتصاره على الصليبيين عندما شعر بِأنَّ لهُ من القُوَّة ما يكفي لِأن يملأ الوظائف الحُكُوميَّة بِمماليكه الذين إصطحبهم معه من الجزيرة الفُراتيَّة، ولمَّا احتجَّ عليه المماليك البحريَّة ردَّ عليهم بِالتهديد والوعيد ثُمَّ أعرض عنهم، وأبعدهم عن المناصب الكُبرى، وجرَّدهم من مظاهر السُلطة وأخيراً أمر بإعتقالهم ،كما تنكَّر لِشجرة الدُّر التي حفظت لهُ مُلكه، فإتهمها بِإخفاء ثروة أبيه، وطالبها بِهذا المال وهدَّدها حتَّى داخلها منه خوفٌ شديد ما حملها على بث شكواها إلى المماليك البحريَّة الذين يُخلصون لها بإعتبارها زوجة معلمهم، ويبدو أنَّ توران شاه، بِالإضافة إلى ضعف شخصيَّته وسُلوكه السيِّء، تأثَّر بِآراء مماليكه الذين قدموا معه من حصن كيفا، وأثاروا ضغينته على المماليكِ البحريَّةِ وشجرِة الدُّر، وحثُّوه على التخلُّص منهم حتَّى يتفرَّد هو بِالحكم وينفردوا هم بالحظوة لدى السلطان ومعاونته في إدارة شُؤون الدولة، نتيجةً لِهذه السياسة الحمقاء حنق المماليك البحريَّة عليه، وتخوَّفوا من نواياه، وإستقرَّ رأيهم على قتله قبل أن يبطش بهم وساندتهم شجرة الدُّر التي باتت تخشى على نفسها من غدره.
تزعَّم المُؤامرة مجموعةٌ من قادة الجند من الأُمراء البحريَّة منهم”فارس الدين أقطاي الجمدار وركن الدين بيبرس البندقداري وسيف الدين قلاوون الصالحي الألفي وعز الدين أيبك التُركماني” ونُفذت المُؤامرة صباح الإثنين 28 مُحرَّم 648هـ المُوافق 2 مايو 1250م، وكان السُلطان آنذاك بِفارسكور يحتفل بإنتصاره ويتهيَّأ لإستعادة دُمياط، فإقتحم بيبرس خيمته، وتقدَّم نحوه وضربه بِسيفه فقُطعت بعض أصابعه، فهرب إلى كشكٍ خشبيٍّ حتَّى يحتمي به، فتعقَّبه المماليك وأحرقوه عليه، فهرب منه ورمى نفسه في النيل، فضربوه بِالسِّهام من كُلِّ ناحيةٍ، فحاول أن يلتمس الرحمة لكنَّ المماليك لم يستجيبوا له، وقفز عليه بيبرس وقتله بِسيفه، فمات جريحاً غريقًا حريقاً، وبمقتله سقطت دولة الأيوبيين بِمصر وقامت دولة المماليك.
كتب:مصطفي خالد